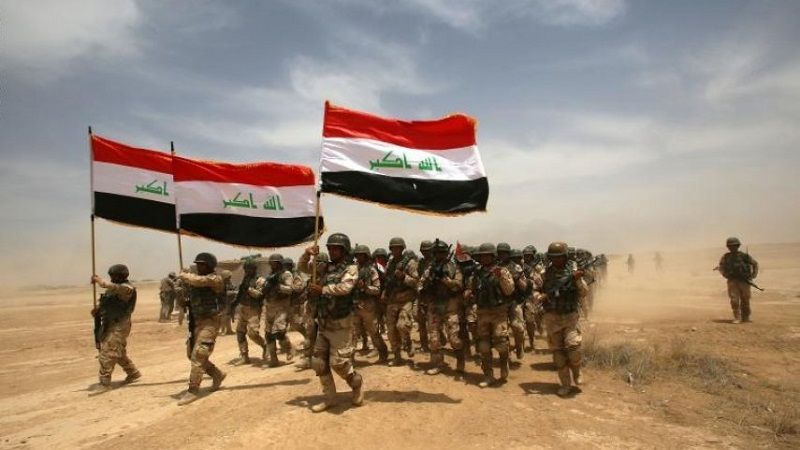آراء وتحليلات
قرار الحرب الأميركي.. من أيزنهاور إلى بايدن
أحمد فؤاد
يتأكد كل يوم، وفي مواجهة أي أزمة، أن الإمبراطورية الأميركية المتجبرة والمنتشرة بطول الأرض وعرضها، لا تشبه أيًا من الإمبراطوريات التي سبقتها، لا البريطانية ولا الفرنسية، ولا أية قوة في التاريخ الإنساني المعروف، قامت واستمرت ووصلت سيطرتها إلى هذا الحد المذهل من امتلاك كل سبل السطوة الخشنة والتأثير الناعم، على الحكومات والشعوب معًا.
منذ اللحظة الأولى التي استقلت فيها الولايات المتحدة عن بريطانيا، في 1776، وبدأ الحلم الأميركي بالسيطرة العالمية، تدفعه موارد هائلة وقوة فتية رأت في نفسها القدرة والإمكانية لوراثة الدور البريطاني في العالم، فورًا بدأ المارينز يعرفون الانتشار على سواحل العالم، بداية من طرابلس الليبية في 1801، وأخذت القوة العسكرية تترجم الطموح الإمبراطوري الجديد، وتتواجد حيث تلمح المغانم والثروات.
والغريب في قصة السيطرة الأميركية على العالم، هي حقيقة أن أباطرة الاقتصاد في الحالة الأميركية كانوا محركي الجيوش ونافخي أبواق الصراعات، وكانت الشركات والسفن التجارية تسبق الوجود العسكري، الذي أصبح تاليًا في وسائل التفوق والتمكين.
ورغم أنها دولة حديثة النشأة، إذا ما قورنت بأي دولة في الشرق الأوسط أو أوروبا الغربية، فقد سجلت الولايات المتحدة قائمة من الحروب تطول وتفوق أية قوة أخرى، من الحروب في آسيا، وتشمل الصين وكوريا واليابان والفلبين وحروبها في البحر المتوسط في ليبيا والجزائر، وتدخلها العسكري المتعدد في كل دول البحر الكاريبي وأميركا الوسطى، وحروبها المستمرة في أميركا الجنوبية، وفوق كل شيء قيادتها لحربين عالميتين، والحرب الباردة بفصولها المثيرة، نهاية بضرباتها الجوية التي توزع الموت والخراب والدمار على كل قارات العالم.
إلا أن الدور الأميركي العالمي الحقيقي بدأ عقب الحرب العالمية الأولى، بدلًا من التدخل القديم لحماية خطوط التجارة والشركات الأميركية، كانت نهاية الحرب العالمية تمنح واشنطن دورًا جديدًا، وبموافقة القوى الكبرى وقتذاك، فقد دخلت لاعبًا أساسيًا ومعترفًا به في الساحة الأوروبية، وعقب نهاية الحرب العالمية الثانية، لم يعد هناك شك في أن واشنطن صارت قائدة العالم الغربي كله، كما أنها كانت خزينة التمويل القادرة والجاهزة، وخرجت من الحرب تمتلك قواعد بطول الأرض وعرضها، في أوروبا الغربية وأميركا الجنوبية وإفريقيا وآسيا وأستراليا.
كان العصر أميركيًا بالكامل، رغم وجود الاتحاد السوفييتي كقوة عظمى ثانية، إلا أن الفارق كان دائمًا لصالح واشنطن، وثروات العالم التي تنزح أولًا بأول كانت تضمن للاقتصاد الأميركي التفوق الساحق، كما أن خروج الصناعة الأميركية -وحدها- سليمة وبكامل قوتها بعد الدمار الذي ضرب كل القوى الأخرى، منح الدولار مكانته كعملة احتياط دولية، ساهمت في دعم صورة واشنطن وهيبتها، وبالتالي عززت سيطرتها التي باتت حقيقة لا تبارى.
هذه القفزة الضخمة التي حوّلت أميركا في سنوات قليلة إلى القوة الأولى عالميًا، باعتراف كل أعدائها قبل أصدقائها، وسمحت بالتالي لشركاتها بالتوسع عالميًا بشكل لم يسبق له مثيل، جعلت من أحد أهم رؤسائها الجنرال دوايت أيزنهاور قلقًا، واختار يوم 17 كانون الثاني/ يناير 1961، لتوجيه خطاب وداع هو الأخطر في تاريخ البيت الأبيض، حذّر وتنبأ واعترف، وترك محاولة تصحيح المسار الأميركي للمستقبل.
بادئاً بتعريف دفاعي، مقصود وفي وقته، قال أيزنهاور إنه يستعد لترك العمل الوطني عقب نصف قرن له في خدمة الولايات المتحدة الأميركية، لكن لديه من الهواجس ما يريد أن يشارك به أمته، إذ رأت صواب أن تحاول تحمل أمانتها مع الرئيس الجديد -وقتذاك- جون كينيدي، أضاف الجنرال السابق أنه يعلم أن بلده تخوض حربًا عقائدية وفكرية واقتصادية ضد عدو كبير وخطير، وستواجه دولته مشاكل وأزمات كبيرة وصغيرة، لكنه يحذر من غواية القوة، ومحاولات فرض وكتابة الحل بدفع من التفوق الأميركي والقدرة التي تتوافر لصانع القرار فيها.

ووصل أيزنهاور إلى الحد الأقصى من المصارحة، باعترافه بتسبب الحرب العالمية الثانية والإنفاق الهائل على التسلح والجيوش في نشأة مجمع عسكري/صناعي، امتد نفوذه بعيدًا جدًا على القرار الأميركي وعلى السياسة الأميركية، وهذا المجمع الهائل للمصالح والمال بحكم سطوة القدرة استطاع التأثير في برامج الإنفاق وأولويات الإدارة الأميركية، وهو مرشح للمزيد من فرض سيطرته على أوصال الدولة الأميركية كاملة.
كانت الشركات التي حذر منها أيزنهاور تواصل زحفها العالمي والأميركي، وأصبحنا في النهاية أمام دولة لا تمتلك رفاهية التراجع عن مركز صدارة الاقتصاد العالمي، وإلا فإن شروط استمرارها ذاتها ستُضرب عند قاعدتها تمامًا، فمناخ السيطرة الأميركي يمنح شركاتها الموارد بشكل مستمر وأرخص من غيرها، ثم يفتح الباب أمام منتجاتها بشكل لا يتوافر لغيرها، ويضمن مصالح المجمع الصناعي العسكري، ويؤمن له استمرار الأرباح واستدامتها.
وهذه بالضبط هي أزمة واشنطن الكبيرة، والمتعلقة بأمنية عنيدة في استمرار سيطرتها العالمية، المهددة برغبة مضادة لدى العديد من الأطراف على القمة الدولية بعالم جديد متعدد الأقطاب، يطوي هذه الصفحة التي طالت من تفرد قطب واحد بالقرار والهيمنة، انخرطت الولايات المتحدة في مواجهتها المصنوعة والمخططة ضد روسيا، وريثة الاتحاد السوفييتي، وفي قلب فضائه السابق، أوكرانيا.
تدرك واشنطن أنها أمام معركة مصير وحسم، قد يكون لما قبلها تأثير ورصيد، في ظل منافسة تقطع الأنفاس بين عالم قديم تشكّل في أعقاب الحرب العالمية الثانية، بسيطرة مطلقة ومتفردة للولايات المتحدة على مفاتيح وكنوز الاقتصاد العالمي ومناجم ثرواته، وبين الصين الطامحة بشدة إلى كسر هذا العلو الأميركي المغتر، ثم المنافسة السياسية الكامنة بين الولايات المتحدة وأوروبا، وقبل الكل قطب عسكري هائل القدرات متعاظم الثقة، هو روسيا.
وفي هذه الأزمة تحديدًا فإن غرور القوة هو ما دفع جو بايدن إلى كسر هذه المعادلة البسيطة التي تركها أيزنهاور، بإخضاع الدولة لمصالح المجمع المالي/ التقني الجديد، والذي يمسك فعلًا بالقرار الأميركي، ويوجه إلى صدام واسع قد يحفظ لواشنطن مكانتها العالمية، لكنه في الغالب سيودي بها إلى الهلاك.
لكن اللحظة التي سيتأكد العالم فيها من خواء القوة الأميركية وتراجعها، ستكون هي لحظة السقوط الأميركي الشامل، المجتمع المخطط على النهب والسيطرة ونشر الحروب والدمار لن يكون مؤهلًا ليعيش في وضع طبيعي، مثل غيره، والشر الأميركي قريب للغاية من حرق القلب الأميركي ذاته هذه المرة.
إقرأ المزيد في: آراء وتحليلات
23/11/2024